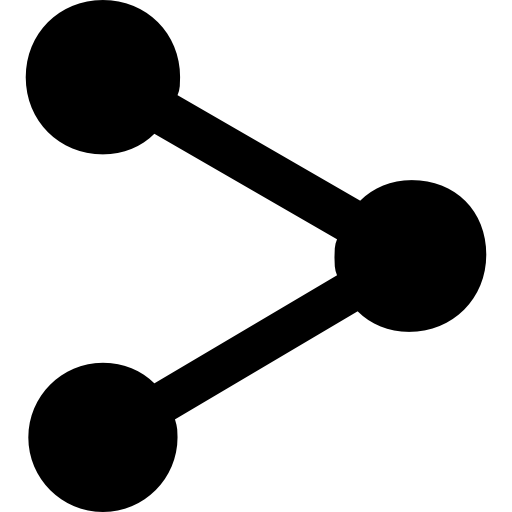سليم عمر
كانت الشمس ، تحتاج إلى أقلّ من ساعة من الزمن ، لتختفي خلف الأنابيب الضخمة ، و السميكة الممتدة من مَعْبر أمّ الدِّبْس ،و حتى التخوم الجنوبية لقرية رفرفْ* ، لتحْجب أنوارها كاملة في يوم من أيام الصيف القائظة ، و قد كان شهر تموز على وشك أن ينتهي ، و كانت القرية لا تزال تعيش نهاراتها الطويلة ، حيث يعودُ الرجال إلى منازلهم ، و الضياء لا يزال يخيم على الكون ، فيأخذون قسطاً من الراحة ، و لما تكن الشمس قد أذنت بالأفول .
كانت الحركة قد انقطعت من أزقة القرية ، و كان بالإمكان القول ، إن الجميع قد عادوا إلى منازلهم بعد يوم طويل من العمل في مزارع القطن ، حيث يشترك أفراد الأسرة كلهم في العمل ، إلا أن الرجال يكونون في الغالب آخر من يعودون ، يحملون أجسادهم على أقدام بالكاد تتحرك على الأرض ، بعد أن هدّهم العمل ، و قد تنقّلوا طوال اليوم في مربّعات الحقول ، يسقون و ينظفون و يحفرون أخاديد المياه ، تختنقُ منهم الأنفاس مع الشمس ، تقفُ بثقلها فوق رؤوسهم ، و تضربُ الأوراقَ العريضة لنباتات القطن التي ، تزداد نمواً في كل لحظة ، فتكشف عن المزيد من الورود البيضاء اللزجة ، تزين منها الأفرع ، و تملأ الجو رطوبة خانقة ، لا تجد معها الأجساد المتعبة ، إلا أن تفرز المزيد من العرَق ، يغسلها من الأعلى إلى الأسفل .
كذلك كانت الأيام تتوالى لشهور طويلة في قريتنا التي ، بدأت أول عهدها صغيرة ، لا تتعدى أُسَرها أصابع اليدين ، لا يربط بينها رابطٌ غير تلك اللحى التي غطّت ذقون أربابها ، و لهذا فقد خمّنتُ أن الصُدفة جمعتْ رجالاتها في أحد مواسم الحج ، ليجدوا أنفسهم بعد ذلك ، و قد جمعتهم قرية واحدة .
و قد تستغربُ ، إذا قلت لك ، بأن هذه الأسر اكتشفت ، و بعد أن استقر بها المقام في رفْرف ، أنها تشترك في أمور أخرى أيضاً ، فهي إلى جانب انتفاء صلة القربى فيما بينها ، فإنها قدِمت من أصقاع مختلفة من الأرض ، و هو ما كان يدفع بالبعض للتّندُّر بها ، بأن الصلة بينها أشبه ، ما تكون بالخبز المصنوع من جريش الشعير ، فهو يتفكك بمجرد لمسه .
و إذا كان ذلك قد سبّب لتلك الأسر إحراجاً في وقت ما ، إلا أنها اكتشفت أن هذه السمة ربما تكون قد أضفت على أبنائها أهمية أكثر وضوحاً ، فقد تلوّنت طبائعهم بالهدوء ، و اللطف ، و المسالمة ، فأنا لا أتذكر أن عراكاً ، أو شجاراً ، أو خصاماً ، وقع بين أبنائها ، صغارهم و كبارهم ، و لو أنك جُبت المعمورة كلها لما وجدت من يتفوق عليهم بِسمَة المسالمة تلك ، و أنا أعتقد جازماً ، بأنه لو قدر لقريتنا ، من يحمل صوتها إلى العالم – حينما كان العالم واسعاً ، كما كان يردّد والدي – لاستحقّت جوائز السلام قبل غيرها ، و لذلك فإن ما حدث في تلك الأمسية كان واقعة نادرة ، لم يسبقْ ، أن وقعتْ عليها رفرفْ .
كان الرجال ، قد جلسوا للتوّ على البُسط الممدّدة في أفنية المنازل ، يتّكئون المخادّ ، أو يتمددون على ظهورهم ، يريحونها من انحناءٍ دام ساعات طويلة ، يغالبُ البعض منهم النعاسَ ، و قد ارتاح في المكان ، و آخرون وجدوا من يحادثونهم ، ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء النسوة من إعداد طعام العشاء ، عندما لمحَ خليل الصوفي حسين ، أن جداراً وطيئاً من قوالب مجففة من روث الماشية ، يفصله عن جاره جميل الحاج خلف ، و قد انتبه لذلك لأنه كان في كل مساء ، يقابل جميلاً مع أسرته التي ، يربو أفرادها عن الثمانية غالبيتهم من البنات في سن الزواج ، يفترشون فناء دارهم ، لا يبتعدون عنهم غيرأذرع قليلة ، و لذلك فإن الرجلين اعتادا أن يتحادثا – و قد جلس كل منهما إلى طعامه – في عمل اليوم و الغد ، و يعرفان في كل مساء ماذا طبخت الأسرة الأخرى ، و غالباً ما يتبادلان صحون الطعام ، إذا تكاسل أحدهما أن يلبي نداء الآخر مشاركته في طعامه .
و مع أن خليل الصوفي حسين ، لم يتزحزحْ من مكانه ، ليعاين الخط الذي بُني عليه الجدار، إلا أنه أدرك تماماً ، أن الجدار قد تجاوز الخط الفاصل بين فناءي المنزلين باتجاهه ، لاحظ ذلك بسهولة ، مع أنه لم يسبق للأسرتين أن حددا خطاً فاصلاً بين منزليهما ، فإلى جانب أن هؤلاء لا يحتاجون إلى خرائط ، و إلى أدواتٍ للمساحة ، لتعيين مثل هذه الحدود ، فإنهم يتمتعون بذاكرة ، تستطيع أن تحتفظ بأشياء صغيرة ، و لأمد طويل ، كما أن أحداً من قريتنا لم يفكر في ذلك ، فقد كانت الأرض واسعة حتى تلك الأمسية ، و كان الواحد يكتفي بفسحة صغيرة تكفي لجلوسه في النهار ، و تسمح له ، أن يمدّد قدميه على طولهما ، إذا حلّ الليل ، أما ما حدث من تبدّل في سلوك أبناء رفرف ، و طبائعهم ، و الرغبة العميقة في أن يستأثر كل منهم بكوكب كامل ، بعد أن وجدوا أن الأرض قد ضاقت بهم ، فقد حصل بعد تلك الأمسية ، عندما شعر خليل الصوفي حسين ، أنه اهتز بعمْق ، كأنما ضُرب بسوط على مؤخرة رأسه ، فلم يمْهله الصبرُ ، لتنتهي زوجته من إعداد طعامه ، عندما صرخ فيها ، يدعوها للمثول أمامه :
– حسينة …. يا حسينة …. أَ لاحظت ، أنت أيضاً ، أن هذا الجدار الرّوْثي ، قد بني في فناء منزلنا ؟ .
و كانت حسينة ، تقف أمامه مع ندائه الأول ، فقد عُرف عن خليل الصوفي حسين ، صرامتُه في المنزل ، وعدم تساهله مع أفراد أسرته ، و أنه يقول الجملة مرة واحدة لتُنفّذ .
فقالت حسينة بصوت غلب عليه الفزَع ُ:
– نعم … لقد لاحظت ذلك . و أردت أن أفاتح جارتنا لطيفة زوجة جميل في ذلك .
– و لكنك لم تفعلي !!؟؟ .
– كنت أريد أن …
– لا ينعقدنّ منك لسان يا حسينة . هيا تحركي واأمري لطيفة أن تزيله الآن .
كان قد اشتدّ به الانفعال حد الاختناق،و شعر ، أن قلبه ، قد تحول إلى مِضخّة الحاج عبدالكريم الشامي ، التي تدفع إلى التخوم الجنوبية للقرية نصف مياه الخابور – قبل أن يختم الخابور نشيده ، و يختفي في باطن الأرض – و أن غشاوة قد غطّت عينيه ، فهو لا يرى ما حوله ، و عندما عاد إلى نفسه في وقت لاحق ، و استذكر بهدوء دقائق الحدث ، لم يعرفْ بالضبط ما الذي دفعه إلى تلك الهاوية : أَ لأن الجدار الروثي قد تجاوز الحدود ، أم لأنه فصَل بينه و بين جاره جميل الذي ، تعوّد على محادثته كل مساء ، لكأنهما يجلسان إلى سفرة واحدة ، و يرى بناته ، يتحركن هنا ،و هناك ، يزيّنّ صحن داره كالورود ، إلا أن الشيئ الذي كان متأكداً منه هو أن التعب كان قد نال منه كثيراً ، و زاد على ذلك الجوعُ الذي ، كان ينهش أمعاءه .
و سواءٌ أكان السبب هذا ، أو ذاك ، أو كلَّ ما دار في خلَده ، فإن زوجته حسينة ، لم تتردّد في تنفيذ ما أمرها به ، و مع أنها ، أرادت ، أن توضح لخليل ، أنها انتهت تقريباً من إعداد الطعام ، و أنها تستطيع أن تنفذ المهمة بعد صلاة المغرب ، إلا أنها ، كانت ، تدرك ، أن أيّ جدل في ذلك ، ستترتّبُ عليه عقوبة إضافية ، و لذلك فإن حسينة ، وضعت كل شيئ من يديها … كل أدوات الطبخ ، حتى مغرفة الحساء وضعتها جانباً ، و أدركت لاحقاً ، أنه كان يتوجب عليها أن تحتفظ بها ، لتهشم بها رأس لطيفة ، عندما وقفتْ قبالتها ، و لأن قريتنا لم تشهد خلال تاريخها الذي امتد حتى تلك الواقعة دُهوراً غير قليلة ، أيّ عراك أو شجار من هذا القبيل ، فإن حسينة ، نشّفت يديها بطرف ثوبها ، و وقفت خلف الجدار الروثي الوطيئ ، أيْ أنها وقفت مباشرة على رأس أسرة جميل الحاج خلف ، التي كانت ستباشر طعامها ، و لكن ليس قبل أن يدعو جميل جاره مشاركته في الطعام ، و قد كان عليه في هذه المرة أن ينهض ، على عكس الأمسيات الخوالي ، حيث كان بإمكانه دعوته و محادثته ، و من غير أن يضطر أي منهما للنهوض .
في البداية احتارت حسينة في الطريقة التي ، يتوجب عليها ، أن تتصرف بها ، و في الكلمات التي ، ستخاطب بها هذه الأسرة التي ، جمعتْها بها ألفة ، و محبة على مدى عقودٍ غير قليلة ، إلا أنها ، وجدت أن لا مناص من الحديث ، و هي تعلم ، أن نظراتِ خليل تدفعها من الخلف .
تلعْثمت أول ما تكلمتْ ، و هي تنظر إلى الدائرة المحيطة بصحن الطعام استعداداً للمباشرة ، و عندما لمحوها ، اعتقدوا أنها ، قدِمت لاستعارة غرض تحتاجه ، فذلك يحدث بين أسر قريتنا في كل وقت ، إلا أن المرأة أغمضتْ عينيها ، و باشرت في كلام غير مترابط ، بدأ بسيطاً ، و هادئاً ، و تضمّن عبارات الجيرة ، و اللّوم ، ثم ارتفع تدريجياً ، ليتحول إلى عبارات السخرية ، و الشتائم ، و التهديد ، و الوعيد .
ذُهلت أسرة جميل الحاج خلف مما وصل أسماعها من عبارات ، و تطلّع أفرادها إلى بعضهم ، و إلى ما حولهم ، و ارتختْ أصابع جميل عن الملعقة ، و هو ، يتأهب لتناول اللقمة الأولى ، و نظر إلى زوجته ، و قال ببرود :
– لا بد أنك تسمعين . إنّ كلامها موجه إلينا .
– أعلم ذلك . فماذا تريدني أن أفعل ؟ .
و مع أن لطيفة كان لها في أسرتها شأن آخر على عكس حسينة ، إذ أنها هي التي تقرّر في النهاية ما الذي يتوجب فعله ، و هي تستطيع ، أن تقرأ جيداً نظرات زوجها في كل مرة يتحدث فيها ، فقد وجدتْ أن الأمر قد انتهى ، و أن عليها ، أن تواجه حسينة على الطرف الآخر من الجدار. فوضعت هي الأخرى ما في يديها ، و لم تترددْ في إسماع حسينة كل العبارات التي تلفّظت بها ، بل زادت على ذلك ، بأنها امرأة جوفاء ، و جاهلة ، و لا رأْي لها ، و إلا لأدركت أن هذا الجدار لا يستحق هذه العبارات .
و لكن ذلك ، لم يفلحْ في إسكات حسينة التي ، ازدادت غضباً و حنقاً ، و هي تسمع من لطيفة هذه العبارات اللاذعة ، و مع أن لطيفة كانت تردد على مسامع جارتها عبارات من هذا القبيل فيما مضى على سبيل الممازحة ، إلا أن الوضع في تلك اللحظة كان مختلفاً تماماً ، فالوقت لم يكن وقت مزاح أبداً ، كما أن جمعاً من أبناء القرية يستمعون إلى ما يدور بينهما و زوجها في المقدمة ، و هذا مما لاقبل لها باحتماله ، و لذلك فإن الغضب قد جمح بها ، فنسيت كل ما حولها ، و أخذت تشعر أن الكلام وحده لا يكفي ، و أن عليها أن تعالج الموقف بأسلوب آخر
و مع أن المرأتين كانتا تقفان مواجهة ، لا يفصل بينهما إلا جدار روثيٌّ وطيئ ، لا يعلو منهما السرّة ، و أنه قد يتهاوى لأول احتكاك لهما به ، إلا أنه بدا أن الجدار قد اكتسب أهميته بل قلْ و قدسيته منذ تلك اللحظة ، إذ بدلاً من أن تضربه حسينة بقدميها العريضتين ، فيتهاوى الجدار ، و تتحطم قوالب الروث المجففة تحت أقدامها ، فإنها آثرت الالتفاف على الجدار ، و ملاقاة لطيفة عند نقطته الجنوبية .
و ما أن تقابلت المرأتان ثانية ، و في هذه المرة من غير جدار ، يفصل بينهما ، حتى امتدت منهما الأيدي ، و اختفتْ أصابع كل منهما في شعْر الأخرى ، و قد أخذت كل منهما تجهد في إنهاك صاحبتها دفعاً و جذباً وصولاً إلى طرحها أرضاً ، بينما كانت العبارات اللاذعة منهما تملأ المكان ، فتثير فيهما الحماس ، و يطول أمَد النزال .
و كما في كل مرة ، و مع كل حدث جديد في قريتنا ، ينتشر الخبرُ بسرعة توازي قدرة سيقان الصغار الدقيقة المسْمرّة على العدْو ، و الانتقال من ساحة القرية إلى بيوتها القليلة المتلاصقة ، و لذلك فإنه ، لم يمضِ وقت طويل حتى بدأ أبناء رفرف يتوافدون : الصبية سبقوا ذويهم مجدداً ، و النسوة توافدن تباعاً ، و كوّنّ نصف دائرة بجانب الصبية.
في البداية لم يعرفْن ، ماذا يحدث بالتحديد ، إذ أن ذلك المشهد لم يكن مألوفاً في قريتنا ، إلا أنهنّ ، و بعد أن سرى الهمسُ بينهن ، وقعْن على كل شيئ. أُصبْن بالذهول ، و انحبستْ الأنفاس منهن في الصدور ، و تجمّد الدم منهن في العروق ، و بدأْن يتحركْن في أماكنهنّ كفرس شُدّ لجامه إلى وتدٍ بحبل قصير ، و كان الانفعال أكثر وضوحاً على أنوفهن ،
عندما وصلت العمة غزالة ، و قد بدا الغضب عليهاجلياً ، فما أن وقعتْ عيناها على ما يدور في النقطة الجنوبية من الحائط الروثي الوطيئ ، حتى ارتفع صوتها تزمجر في المرْأتين بلهجة آمرة ، و هي تقترب منهما بخطوات سريعة ، تمسك بثوبها الطويل من أطرافه ، خشية أن يلتفّ على ساقيها ، فيحدَّ من اندفاعها :
– أنتما أيتها ال …. يا حسينة .. يا لطيفة .. كفّا عن ذلك هيا ..
و قبل أن تكمل العمة غزالة آخر كلمة ، كانت المرأتان قد انفصلتا عن بعضهما : عيناهما إلى الأرض ، يتسارع منهما النفس ، و الإعياء ظاهر على سَحْنتيهما ، أما شعرهما فقد كان في حالة مزرية .
و جاء صوت زوجيهما معاً :
– دعيهما يا عمة غزالة … إنهما لم تنتهيا بعد .
– و ما الذي يتوجب عليهما ، أن تفعلاه ، لتكونا منتهيتين يا أيها الرجلان ؟
قالت ذلك بغضب و بلهجة ساخرة .
و مع أنهما ، شعرا بشيئ من الحرج ، إلا أنهما لم يُمعنا الفكر في مغزى كلامها ، عندما أكملت بنفس اللهجة :
– أ هما قردتان ، فأنتما ، تتفرجان عليهما ، و هما تتعاركان في هذه الساحة ؟ فأسرع خليل يجاوبها ، و قد ركبه نوع من الخجل :
– الأمر ليس كذلك يا عمة غزالة . هناك مشكلة يتوجب عليهما معالجتها .
– و لماذا لا تعالجها أنت بنفسك مع جارك ، إذا كنت تؤْثر الحقيقة .
و كمن يفتح عينيه للتو على حقيقة ، ظلت لأمد طويل غائبة عن ذهنه ، وجد خليل نفسه أمام واقع جديد . عليه أن يكمل ما لم يتسنّ لزوجته الانتهاء منه . و في مجتمع ريفي فإن أي تقاعس في ذلك لا يعني غير شيئ واحد : أن يصبح الرجل مثار السخرية في المجالس ، و أن يطأطيئ الرأس ، إذا ما التقتْ عيناه بأعين الآخرين ، و هو ما لم يدُرْ بخلده ، و لم ينتبه قط إلى أن الأمور قد تتطور في هذا الاتجاه ، و مع أنّ التعب ، و الجوع ، كانا قد أنهكاه بما فيه الكفاية ، إلى درجة أنه كان يشحذ الهمة بين الفينة و الفينة ليتوضأ استعداداً لصلاة المغرب ، إلا أنه وجد نفسه ينهض فجأة ، و في قرية يعمل جميع أبنائها في حقول القطن ، فإنك ، تعثر على المعاول ، و على المجارف ، و على المعازق في كل مكان ، و بلحظة تناول خليلٌ مجرفة ، و اتجه صوب جاره .
و تفادى هو الآخر الاحتكاك بالجدار ، ربما حرصاً منه من أن تتحطم قوالبُ الروث الجافة ، و هو يرفسها في لحظة غضب ، أو أن تنفلت منه ضربة مجرفة ، فتتبعثر في كل مكان ، فقد تكونت لديه هو الآخر قناعة ، بأن مسؤولية هدم الجدار ، تقع على عاتق من بناه ، و لذلك فإنه لقي جميلاً في نهاية الجدار من الشمال ، حيث كان المكان خالياً ، و كان بإمكانهماأن يرفعا مجرفتيهما عالياً ، و بدون خشية من أن يصيبا أحداً .
و على عكس زوجتيهما ، فقد تطلّع كل منهما في عيني الآخر مباشرة ، و من غير أن يرمش لهما جفن ، إذ أن من الظاهر أن الرجل ينسلخ من جلده ، بل من آدميته إذا ما عصف به الغضب ، و ذلك على عكس المرأة التي تظل ، تحتفظ بألق كاف ، يشدها إلى أنوثتها .
و في لحظة واحدة رفع كل منهما مجرفته عالياً ، و هوى بها على صاحبه ، و لكي ينال أحدهما من الآخر ، فإن المجرفتين هوتا في اتجاهين مختلفين ، فقد هتكتْ مجرفة خليل الساعد الأيسر لصاحبه ، بينما مزقت مجرفة جميل الساق الأيسر لخليل ، و سقط الاثنان أرضاً ، و ارتمت مجرفتاهما على بعد أذرع منهما ، و قد فقدا القدرة على كل حركة ، و قبل أن يفكرا في الخطوة التالية ، كان رجال القرية ، يقفون على رأسيهما ، و أخذوا ينقلون كلاً منهما إلى المكان الذي كان يرتاح فيه قبل دقائق قليلة .
و قد تستغرب ، إذا قلت لك ،إنني لا أعرف حتى الآن ، كيف انقسم رجال رفرف إلى فريقين ، و قد كنا نعتقد على الدوام ، أن أبناءها الذين أمضوا العقود غير القليلة ، ينسجون خلالها روابط من الألفة قد شكلوا أسرة كبيرة ، إلا أن ذلك الجدار الروثي ، قد كشف عن غير ذلك ، فقد انقسمت قريتنا إلى فريقين متماثلين ،و ظلّ العداء مستعراً بينهما حتى هذه اللحظة ، و قد اكتشفنا فيما بعد أن تكافؤهما لم يكن مصادفة ، و إنما كان بقصد استمرار النزاع ، وديمومة الخصومة ، بل و علمنا أيضاً أن الرجال تعمّدوا في الوصول متأخرين ، لينال الرجلان من بعضهما ، و حتى العمة غزالة التي ، توسّمْنا فيها الحكمة و الاستقامة ، لم تقف على الحياد ، و لو أنها أكدت أنها انحازت إلى هذا الفريق دون الآخر بعد أن استخارت ربها ، و أظهرت هي الأخرى من الأحقاد و سوء النية ما لا يقل عن الباقين ، و ما لم يكن يخطر على بال ، و قد بدا جلياً – و منذ ذلك المساء – أن جرحاً عميقاً غائراً ، لم ينفتح في ذراع ، و ساق الرجلين – خليل و جميل – فحسب و إنما في جسد قريتنا أيضاً ، و أن معالجته أصبح مستحيلاً ، بعدما دار من نقاش حاد ، و طويل ، و متواصل ، و قد وجد كل فريق ما يمكنه من الإصرار على موقفه ، ففي الوقت الذي رأى فيه أنصار خليل الصوفي حسين ، أن ما أقدم عليه جميل الحاج خلف يعتبر اعتداء سافراً ،و سابقة غير مبررة بكل المقاييس ، و أنه يستحق على ذلك قطع أذنيه و جَدْع أنفه ، و جد الفريق الثاني ، أن ردّة الفعل لدى خليل تعدّت كل الأعراف ، و لم تناسب أبدا قيم الانتماء للقرية الواحدة ، و صلة الجوار .
و مع أن الجدار الروثي قد أتى عليه النار في الشتاء ، و ذاب ما بقي منه في عواصف الثلج و المطر ، إلا أن ذلك الخط الذي رسمه ، و الجرح الذي أحدثه ، ظل محفوراً في الأعماق ، و لم يمض وقت طويل ، حتى و جدنا الجدران ، تنتصب في كل مكان من قريتنا ، فتعْزل بين بيوتها ، و ناسها ، و لم تُبنَ في هذه المرة من قوالب الروث الرخوة ، و إنما من حجارة قُدّتْ من قلوب أبناء رفرف ، و في وقت لاحق ، و عندما عاد والدي من إحدى رحلاته ، و قد كان كثير الترحال ، يزور الأماكن القصيّة من العالم ، فقد كان ، يزور مدينة الحسكة ، و مدينة عامودا ، و ماردين ، و زار مرة واحدة مدينة حلب ، و كانت الحيرة و الكآبة ظاهرتين على سَحْنته ، عندما سألتْه أمي عما شاهده في رحلته ، فقال بحسرة :
– لقد انتشر خبرُ جدار رفرف في كل مكان في المعمورة . و صار حديثَ الناس ، و في كل مكان مررْت به ، كانت الجدران من كل صنف ، و نوع ، ترتفعُ ، و تقسم الأرض بين البشر ، و تعزلهم عن بعضهم . لقد أصبح الواحد لا يحتمل وجود الآخر .
*رفرف : قرية تقع على الجانب الجنوبي من نهر الخابور ، و إلى الغرب من مدينة الحسكة مسافة ساعتين سيراً على الأقدام .
salimbahoz@hotmail.com
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية